الحقيقة ناقش الباحث الدكتور وفيق سليطين من مركز دمشق للدراسات والأبحاث /مداد/ في مقال له ما جاء في كتاب أدونيس ««غبار المدن بؤس التاريخ» بمقال حمل عنوان « منطق التماثل ودعوى الاستمرارية في فكر أدونيس». وقال الباحث سليطين في مقاله: لا يخفى أنّ ما ينطوي عليه هذا العنوان يجري على وفاق القول بالخصوصيات الحضارية الثابتة
الحقيقة
ناقش الباحث الدكتور وفيق سليطين من مركز دمشق للدراسات والأبحاث /مداد/ في مقال له ما جاء في كتاب أدونيس ««غبار المدن بؤس التاريخ» بمقال حمل عنوان « منطق التماثل ودعوى الاستمرارية في فكر أدونيس».
وقال الباحث سليطين في مقاله:
لا يخفى أنّ ما ينطوي عليه هذا العنوان يجري على وفاق القول بالخصوصيات الحضارية الثابتة التي تتعدّى مراحل التطور التاريخي، بل تخترقها جميعاً، وتشدّها إليها، بوصفها الجوهر الذي تقوم به ويتوالى دورانها عليه، فيكون الإحداث في الزمن إحلالاً جديداً لما كان، أو متابعة له وامتداداً به، في حركة لا تفارق الأصل الذي تتعيّن بدلالته، وهو ما يعطّل فيها معنى الحركة، إذْ تغدو مكفوفةً به، فضلاً عن كونها مجعولة له
في مسار مضروب من قبل، يكون التقدّم فيه ارتداداً إلى الأصل، ومطابقةً له، وتكشفاً عنه في واقع التحول الجديد.
سأقتصر، في مناقشة هذا الموضوع، على بعض ما جاء في كتاب أدونيس غبار المدن بؤس التاريخ، وهو كتاب يتألف من مقالات ينعقد معظمها على تناول ما أسفرت عنه وقائع “الربيع العربي”، وعلى تشخيص محركاتها الفكرية والإيديولوجية، وإعادة ربطها بالأصل، أو بالجوهر المحدّد للتاريخ العربي في تجلياته وقواسمه المشتركة بين السلطة والمعارضة. أما مقالات الكتاب الأخرى فلا تخرج عموماً عن هذا السياق، وإن كان منها ما يتقدم زمنياً أحداث “الربيع العربي”، ويتصل بمناقشة مشكلة من المشكلات التي يعرض لها أدونيس ويدرجها في هذا الإطار الذي تتخلّله أيضاً وقفات إنشائية، ومقاطع شعرية، تستدعي التريّث والتأمل، وتنعطف بدلالاتها على مركز التأليف المتمحور على مساءلة الواقع العربي ومواجهة مواطن الاستعصاء المسكوت عنها، قصداً، في الفكر والممارسة.
في مقدمة الكتاب الموسومة بـ “هيام الانشقاق والرفض”، يقول أدونيس: «يكشف (الربيع العربي) عن هيام عريق عند العرب، هو هيام الانشقاق والرفض، ذلك الذي عرفه تاريخنا في جميع مراحله، فهو جزء عضوي من البنية السياسية العربية، منذ نشوء (الدولة) الإسلامية الأولى، (دولة) الخلفاء. وقد عبّر عن نفسه دائماً، وعلى نحو مباشر، برفض السلطة القائمة. لم يُعنَ بالمجتمع في ذاته، وإنما عُني بحكمه، وبمن يتولّى هذا الحكم. ولم يهتمّ بتغييره، إذْ يفترض فيه أنه مجتمع كامل بالإسلام الذي ارتضاه ديناً وحياةً، وإنما اهتمّ بانحرافات السلطة، أي بالقضاء عليها، وإحلال سلطة جديدة محلّها».
أردتُ أن أبدأ بهذا التصدير لاستخلاص المحددات الأساسية لرؤية أدونيس، على نحو ما ينطق بها الشاهد من كلامه، وفق الآتي:
إن أفعال الرفض والانشقاق هي جِبلّة تكوينية فُطر عليها المجتمع العربي، فغدت الأساس الذي يصدر عنه في الفكر والممارسة.
ما جهر به “الربيع العربي” من الرفض والانشقاق لم يكن إلّا هياماً موروثاً. ويعني ذلك أنه يعود إلى ما انطوى عليه الأصل التكويني، بمعزل عن وجود مرتكزاته في الواقع أو عدم وجودها.
يذهب أدونيس إلى إنشاء فصل تام بين السلطة والمجتمع، أو بين السلطة والمؤسسات العاملة في المجتمع، ويدعم ذلك بقوله:
«يؤكد لنا هذا الواقع التاريخي أن الثورة في المجتمع العربي لا تتمّ إلا إذا كانت قطيعة مع ماضيه المتواصل: لا مع السلطة وحدها، وإنما مع البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية».
سيادة النظرة التجريدية في التعامل مع مطلقات مرفوعة فوق شروط تعيينها، بحيث يغدو من السائغ شكلياً أن يقال إن تاريخ الرفض العربي لم يكن إلا لتقويض سلطة وإحلال سلطة أخرى محلّها هي وجه آخر للسلطة المقوّضة، بدليل أن هذا التغيير السلطوي لا ينال المجتمع، ولا يحدث أي تأثير في مؤسساته، فيبقى كما كان عليه من قبل، وبمثل ذلك تبقى السلطة هي السلطة نفسها في دوران عملية الاستمرارية التاريخية التي تنتج دوراتها المتطابقة.
يضاف إلى ما سبق تعزيز النظرة الجوهرانية إلى الدين، بإنزاله منزلة العلّة الأولى الفاعلة في هذا السياق، على النحو الذي يكفّ معه عن أن يكون تعبيراً إيديولوجياً عن مصالح بشرية وتحيّزات دنيوية.
وهو ما يؤكده أدونيس بقوله: «يتّضح من هذا العرض الموجز أن المشكلة العربية الأولى، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، تكمن في إعطاء الأوّلية المطلقة للنص الديني، ضد التجربة، وضدّ العلم، وضدّ الإنسان في الأخير».
يتكشّف تصدير أدونيس لكتابه “غبار المدن بؤس التاريخ” عن رؤية خصوصية للمجتمع العربي تحكمه عناصرها الثابتة المتعاضدة بنيوياً على امتداد خمسة عشر قرناً، ظلّ فيها التغيير شكلياً ومشدوداً إلى مركز التأسيس في ماضي الذات، منذ “دولة” الخلافة الأولى كما يقول.
ومن الواضح أن مثل هذه الأطروحة –حتى تستقيم شكلياً– لابدّ من أن تقوم على عمليات من الاختزال المضاعف: اختزال حركة التاريخ في تعقّد مجراها وتشابك فروعها، لتكون امتداداً خطياً بين ماضي الذات وحاضرها، أي إنها تنطلق من الماضي لتنتهي إليه في صورة الحاضر. وضمن هذا الاختزال الأساسي، يتعين اختزال فاعليات القوى الاجتماعية الحاملة للتغيير، لتكون مجرد استجابة نسقية تنتهي عند حدّ إبدال سلطة بسلطة، بحيث يستمر النسق المؤسس في عمليات الاستبدال المتعاقبة. وليس آخر ضروب الاختزال، في هذا الإنشاء، التعامي عن رؤية اللحظات المفصلية لجدل الاتصال والانقطاع المفضي إلى تمايز عناصر الوحدة المركّبة وإعادة تأسيس لحمتها من جديد لتحقيقها في طور أعلى.
على أثر هذه الاختزالات يتبدّى التماسك الظاهري للأطروحة. ويعني ذلك –فيما يعنيه– أن هذه النظرة تعمل على ابتسار الواقع لإجباره على مطابقة الأطروحة. فهي، على هذه الحال، لا تسبر الواقع بفعلها الخاص، بل تقدُّه على مقاسها. ومن السائغ أن نتساءل هنا عن جدوى القول بالتغيير، إذا كان ما يتكلّم عليه أدونيس هو علّة تكوينية، لأن الخصوصية المنظورة في هذا التشخيص ستكون شيئاً من عمل الطبيعة لا من فعل التاريخ. أما إذا كانت الخصوصية المشار إليها خصوصية تاريخية، فهي، بحكم كونها كذلك، خصوصية مرحلية متغيرة في مجرى “تمرحل” التاريخ، واختلاف أوضاعه، وتغاير أشكال الوعي به وفيه. وعندئذٍ ستكون هي نفسها منسوجة بجدل الثبات والتحوّل، ومركّبة بتفاعل عناصر الاستمرار والانقطاع، وبتجدّد حضورها في هذه الصيرورة. وفي هذه الحال يكون السؤال واجباً عن مقولة التماثل الخصوصي لحركة المجتمع العربي طوال خمسة عشر عاماً.
في منطق أدونيس فصل باتّ –أو يكاد يكون كذلك– بين السلطة والمجتمع، ولذلك يرى أن ما درج عليه المجتمع العربي من تغيير للسلطة لم يمس المجتمع، ولم يحدث فيه أي تغيير. والنتيجة أن السلطة تتغيّر ويبقى المجتمع على حاله، «فالثورة تكون بالإسلام ضدّ السلطة المنحرفة، أو لا تكون هي نفسها إلا انحرافاً».
إذا ما غضضنا النظر، في مثل هذا التوجه، عن اختزال المجتمع ومكوناته بالإسلام، فإن في الرؤية القائمة على “الفصل” تغييباً للعلاقة بين الجانبين، ولأثر كلّ منهما في الآخر بتفاعله معه وحضوره فيه. وكأنّ في الإمكان تغيير المجتمع دون مساس بالسلطة، أو تغيير السلطة دون تغيير يطول مؤسسات المجتمع التي هي شكل حضور السلطة فيه، من حيث هي أجهزة تقوم عليها، وتتولّاها بالتوجيه والتنظيم. وإذا ما افترضنا أن هذا المنطق يستوي في قيامه على “الفَصْل”، فإن ما يذهب إليه أدونيس سيكون آنئذٍ تغييراً في السلطة لا تغييراً لها. ومن هنا، على الأرجح، يستمدّ رؤيته للصراع السياسي في المجتمع العربي الإسلامي، فيسمه بكونه صراعاً دائرياً يكرّر نفسه باستمرار. وهذا وجه ينضوي إلى غيره من وجوه القول بدعوى الاستمرارية وثباتها الخصوصي.
يبني أدونيس دعواه السابقة في الاستمرارية على القول بثبات العقيدة واكتمالها المطلق في المجتمع العربي، فهو مجتمع مكتفٍ بذاته، مُكتمل بتعاليمه الدينية. وهذا الاكتمال هو مسوّغ التكرار في جريانه على محيط الدائرة نفسها. واستناداً إلى فرانسوا شاتليه في وصفه العقيدة بأنها استلاب وتضليل وتشييء، يقول أدونيس بصيغة التقرير: “أليست النظرية هي نفسها عقيدة؟” وعلى ذلك يتساءل: “كيف يمكن تحرير الثورة من البعد العقدي؟”.
انطلاقاً من هذه المساءلة، يمكن أن نتوقف عند أمرين اثنين: أولهما أن عدم التدقيق المفهومي يسهل انزلاق هذا المنطق في مسار الجمع والتوفيق والوصل بين الأشياء المتمايزة عندما يقتضي الأمر ذلك، تأكيداً للمقولة التي يصدر عنها. فلا يخفى على أدونيس أن النظرية غير العقيدة، ولا يعوزه إنشاء الفرق بينهما، من حيث إن النظرية قابلة للتعديل والتصحيح، على خلاف العقيدة المنغلقة على نفسها في معنى اليقين المطلق الذي يجعل منها قولاً دوغمائياً مصمتاً يندُّ عن المساءلة، ويفلت من التحديدات الظرفية، ويعلو على التاريخ الذي ينبثق منه ويحدث فيه. وثانيهما أن “الثورة” يجب أن تكون مكتملة من مختلف جوانب التأهيل النظري لتنطلق إلى الفعل، أو لتنتقل، في ضمان كامل، من عالم الأذهان إلى عالم الأعيان. وإذا لم تكن كذلك وجب أن تنتهي إلى ذلك المسار الدائري الممتدّ تاريخياً في دعوى الاستمرارية.
صحيحٌ أن أدونيس يطلق فاعلية النقد لينال بها طرفي التقابل، وليكشف عن أوجه النقص والقصور من جهتي السلطة والمعارضة، وليصل ذلك كلّه بثقافة الاستنقاع الموروثة في امتدادها الذي يخترق مراحل التاريخ العربي، وهو نقد يستحقّ العناية والتثمين في حركته المزدوجة وفعله المضاعف. وقد لا يختلف معه كثيرٌ من أهل النظر في قوله إن السلطات العربية لم تفعل ما يمكن الاعتزاز به حضارياً، بل إنها استغلّت أمراض الماضي جميعاً من أجل إحكام السيطرة على شعوبها، فنقلتها من العيش في عبودية الخارج إلى العيش في عبودية الداخل. ولكن ذلك لا يرجع إلى علّة متأصلة في صميم تكوين الذات العربية وتاريخها الخاص، خلافاً لما يذهب إليه أدونيس ويؤكده، منذ مشروعه التأسيسي في “الثابت والمتحول”. هذا، على أن نقد أدونيس يبقى قائماً على مستوى العقل المجرد، ويبقى موصولاً بعلّته الماثلة في ماضي الذات، والمستمرّة إلى الآن بحضورها المتجدد في دورات الزمن الذي يبقى زمناً لا يخترقه التاريخ، ولا يشكل قطعاً في مجراه. وفضلاً عن ذلك، فإن ما يعوّل عليه أدونيس من نقد العقل –على ما له من أهمية– يبدو، من وجه آخر، حجاباً يغيّب تحته الأسباب القائمة في الواقع الموضوعي. وعلى هذا النحو يكتفي هذا الضرب من النقد بتفسير الأزمة تفسيراً إبستمولوجياً، فتكون أزمة العقل من صميم سماته التكوينية والبنيوية، ولذلك كان من شأن هذا النقد أن ينتهي إلى التثبيت اللاتاريخي لهذه السمات.
ركائز التماثل والاستمرارية في فكر أدونيس
في محاورة منطق التماثل ودعوى الاستمرارية الخصوصية، يمكن أن نتوقف ههنا عند ركيزتين أساسيتين يستمد منهما هذا الفكر ما يدعم منطقه، ويبني عليهما ما يسوّغ مقولاته. ومن هنا كانت محاورته تقتضي تجاوز التفصيلات للحفر عن الأساس الذي يقوم عليه، ويتقوّى به، ويسترفد منه.
أولاً: المنزع التجريدي
عندما تُستَلُّ الأفكار من تربتها الاجتماعية التاريخية، يجري التعامل معها بوصفها وجوداً قائماً بذاته، يتخطّى التاريخ، ويفلت من تحديداته وقرائنه التي تقيّد المعاني المطلقة، وتشد الفكر إلى أرض الواقع التاريخي الذي انطلق منه، وتشكّل فيه، وعاد بفعله لينصبّ عليه في عمليات التفاعل التي لا تكف عن الحركة والتناتُج. ويعني ذلك أن التعامل مع الأفكار خارج وجودها في بنية فكرية، وبصرف النظر عن كل تعيين مرجعي، يتيح إمكان مطابقة بعضها ببعض، في فهم ينتج قرانها الموحِّد فوق فواصل التاريخ، وفوق تغاير الشروط الاجتماعية والثقافية الخاصة بكل مرحلة من مراحل التطور، وبهذا تغدو الفكرة الواحدة قبل قطائع التاريخ الحديث وبعدها هي نفسها في عمليات التجريد والنفي المرجعي.
من لوازم هذا الفهم أنه لا يولي الأبعاد العلائقية ما تستحقّه، بل ما توجبه، من ضرورات التحديد والتمييز بين سياق وآخر، وبين بنية فكرية وأخرى، في مراحل التطور الاجتماعي التاريخي، وهو ما يسهّل الكلام على الأفكار بصفتها هي هي من قبل ومن بعد. ونتيجة ذلك أنه لا يلحظ فروق التطور وتمايزاته في اختلاف الأوضاع والأحوال، وفي تحول أشكال الوعي التاريخي وتفاصل الأزمنة الثقافية ومنجزات المعرفة. على هذا النحو يسهل تثبيت الأفكار، فتبقى كما كانت عليه في وجودها السابح فوق كل تعيين. وعلى ذلك فإن دعوى الاستمرارية تقوم على التغافل عن وجود الأفكار في بنية تتحدد بها أولاً، وعلى الانصراف ثانياً عن رؤية هذه الأفكار في تطورها واختلافها في منحى تحلّل البنية، وتمايز عناصرها، واستعادة وحدتها في تركيب جديد. وهكذا تنتج دعوى الاستمرارية الخصوصية زمناً راكداً متكرر الآنات يمتدّ بين الماضي والحاضر في ثوابته المجرّدة وأنماطه الثابتة. على وفق ذلك يكون الزمن العربي زمناً دائرياً في تماثل وحداته، وتكون الأرض العربية –كما يعبّر أدونيس– أرضاً تكتبها يد الغيب. وعلى وفق ذلك أيضاً يأتي قوله: «تلك هي مسيرة المجتمع العربي منذ أن هيمنت عليه الخلافة العثمانية. يعيش دون رؤية، دون مشروع، ودون علم، ودون فن، ودون فلسفة، ودون عمل، غير الاقتتال المذهبي، والقبلي، والطائفي، وتكفير الناس بعضهم بعضاً، وذبح بعضهم بعضاً».
ثانياً: المنزع الثقافوي
لا ينفصل هذا المنزع عمّا سبقه، بل إنه يلتقي به ويعضده في عمليات التجريد التي تعلي الثقافة، وتفكّ علاقتها بشروط إنتاجها، لينتهي فاعلوها إلى القول بوجود عناصر ثقافية خصوصية تتعدّى مراحل التطور التاريخي. هذا، وقد بيّن تيري إيجلتون ما ينطوي عليه هذا المنزع من إيلاء الأهمية القصوى للثقافة، من حيث هي نظام القيم الأساسي للمجتمع.
من هذا المنطلق ترى الثقافوية أن كل مجتمع يميل إلى تشكيل كلٍّ ثقافيّ فريد يميزه من غيره، على النحو الذي يبدو معه أن هذه الهوية الثقافية لا يخترقها الصراع، ولا يتخلّلها التنوع، وتتبدّى أهميتها في أنها تسم الكلّ الاجتماعي وتطبعه بطابعها الخاص في مختلف مراحل تطوّره. ويعني ذلك أنها تُحدّد استجابته، وتضرب نطاقها على مدى الإمكان الذي يتيحه أو يقبل الانفتاح عليه، لدرجة قد تصل بها إلى ما يشبه النزعة الحتمية. هكذا تتمخض الثقافوية عن رؤية ساكنة للمجتمع، فالهوية التي شكّلته وتشكّل بها تغدو ملازمة له، وحاكمة لطريقة حضوره في العالم، بمعزل عن اختلاف الشروط الموضوعية التي تبقى متنحيّة إلى حد أو آخر، ومتلاشية الأثر في تحديد طبيعة ذلك الحضور.
هكذا يظلّ التاريخ العربي “دورات دموية متكررة”، في متّصل لا يعروه الانقطاع. وإذا ما عرف تاريخنا صورةً –ولو ضامرة– من صور الانقطاع، فإنها تتعيّن بوصفها لحظةً لإطلاق فاعلية الاستمرار، ولإكسابها دفعاً إلى الأمام في متّصل دائرية زمنها الخاص، لأن الحركة هنا هي الحركة التي يتجدّد بها حضور الجوهر نفسه. وعلى هذا الأساس يؤكّد أدونيس أن الصراع بين الاتجاهات السياسية في المجتمع العربي–الإسلامي يمكن أن نصفه «بأنه صراع دائري يكرّر نفسه باستمرار».
ومن آيات المنزع الثقافوي لدى أدونيس أنه يجعل للدين؛ أو للثقافة الدينية، الأثر الأعظم في تكوين المجتمع العربي، ويعلّق عليها أسباب التخلّف والالتحاق بإدارة الغيب على امتداد هذا التاريخ. وفي هذا الفهم ما يعكس التراتب، أو يبدّل المواقع بين النتائج والأسباب، جرياً على سنَن “التثبيت” الذي تكون دعوى الاستمرارية متحصّلةً منه، وراجعةً إليه. وعلى ذلك يقرّر أدونيس أن «المشكلة العربية الأساسية، من هذه الزاوية، هي، في المقام الأول، فكرية – ثقافية»، وهو أمر يستدعي تجديد الحوار مع فكر أدونيس. وليس ما قدّمته هنا من نقدٍ إلّا ضرباً من الحوار الذي يكون به احترام الفكر إنتاجاً نقدياً له.
الحقيقة



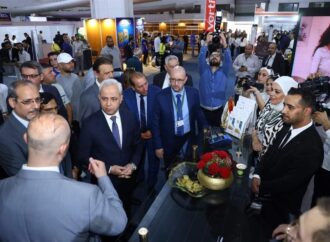
















اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *