الحقيقة تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد السوري وصل في نهاية فترة الحرب إلى مفترق طرق. نبدأ بالناتج المحلي الإجمالي والذي يعدّ أهم المؤشرات الاقتصادية التي ينظر لها أي مستثمر قبل أن يبدأ التفكير بالاستثمار في بلد ما. دخلت سورية حربها وكان ناتجها المحلي يقدر بـ 65 مليار دولار سنويا. لينخفض في عام 2013
الحقيقة
تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد السوري وصل في نهاية فترة الحرب إلى مفترق طرق.
نبدأ بالناتج المحلي الإجمالي والذي يعدّ أهم المؤشرات الاقتصادية التي ينظر لها أي مستثمر قبل أن يبدأ التفكير بالاستثمار في بلد ما.
دخلت سورية حربها وكان ناتجها المحلي يقدر بـ 65 مليار دولار سنويا. لينخفض في عام 2013 إلى 60 مليارا، ليعود بعد ذلك للانخفاض بحدة في عامي 2017 و2018، حيث وصل إلى 24 مليار دولار تقديريا حسب سعر الصرف.
تقبع مرتبة اقتصاد سورية بالإجمالي نسبةً لباقي دول العالم عند 110 مع نهاية حربها الآن، موازياً الاقتصاد اليمني الذي مازال يعاني حربا جائرة.
الثبات شيء سلبي، والمؤشر عندما يتم تقديمه كمحصلة مؤشرات إيجابية وسلبية؛ لا يدل إلا على أننا في مرحلة تسيير أعمال، مازالت تحافظ فيها سورية على المرتبة الأولى عالميا، كأفقر شعب في العالم بنسبة سكان 82% يعيشون بأقل من 2 دولار يوميا منذ عام 2014 إلى الآن .
الدولاران في اليوم يعدّان اقتصاديا خط الفقر المتمثل بعجز الإنسان عن كفاية نفسه بشيء، سوى الحد الأدنى من الغذاء؛ هذا المعدل يتماهى مع الرواتب المنخفضة، حيث تحتل سورية المرتبة الأخيرة في دول العالم من حيث الرواتب، رغم غناها بالثروات، وهذا يجعل من السكان يبدون كحراس فقراء لمناجم ذهب ويتضورون فقرا لكفاية فواتيره.
تشكل الزراعة في الاقتصاد السوري ما نسبته 20%، وتأتي سورية بمرتبة متقدمة جدا (44 من أصل 144) دولة في العالم تزرع، إذاً المشكلة ليست في المساحات المزروعة من البلاد ضمن المساحات المؤهلة للزراعة (أعلى من 70%)، وليست المشكلة أيضا في 16% من السكان الذين يعملون بالزراعة، هل المشكلة في الانتاج؟! فنوعية المنتجات السورية من أفضل الأنواع في المنطقة من حيث تصنيفات الجودة الزراعية، المشكلة في الكمية وليست النوعية؛ فنحن ننتج أكثر بأضعاف مما نستهلك من الحمضيات مثلا، مما يدفع الفلاحين لرمي المحصول من دون بيع كل سنة، بينما نعاني من ارتفاع أسعار البطاطا والبندورة التي نضطر لاستيرادها لتغطية الاستهلاك. حل المشكلة عادة ليس في تقنين الاستهلاك في منتج كما يسوّق له بعض المارة بالاقتصاد، بل بدعم إنتاج النقص لتحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول.
أما فيما يتعلق بالصناعة، تقول المؤشرات بأن 19% من الناتج المحلي الإجمالي السوري يأتي من الصناعة.
ويعمل في القطاع الصناعي 17% من إجمالي العاملين، وهي نسبة قليلة جدا ولكنها طبيعية، فمن سيودّ العمل براتب قليل جدا يؤهله ليستمر في خط الفقر إلى الأبد ولساعات طويلة! ويسدد فوقها الضرائب؟
هذا ينقلنا إلى البطالة، لنتحدث عنها قليلا، نسبتها خلال الحرب 50% واستمرت النسبة بالتأرجح زيادة حتى أصبحت بعد الحرب 59% من السكان الذين يستطيعون العمل ولا يعملون؛ إذ يبدو العمل غير مجدٍ إن كان الدخل يساوي إنفاق النقل! أليس كذلك؟ ومع ذلك ارتفع عدد الموظفين إلى 3 مليون و700 ألف موظف في القطاعين. كيف للبطالة أن ترتفع والتوظيف أن يرتفع في نفس الوقت؟ هذا سر خلطة البطالة المقنعة بأن تعمل دون جدوى إنتاجية، فلا أنت تستطيع تحريك الأسواق بإنفاقك المعدوم الذي يتمثل بمواصلات وربطة خبز يوميا وبعض الخضار؛ ولا أنت قادر على الاستغناء عن الإعالة. لا بد من الإشارة هنا إلى أن نسبة الشعب السوري المعال من الآخرين تجاوزت 72%؛ ثلاثة أرباع الشعب يصرف عليه آخرون لأن عمله لا يكفي لطعامه، أو لأنه لا يجد عملا بجدوى اقتصادية لتوفير بعض الليرات فيتوقف عن العمل؛ الفقر هو ما يولد البطالة هذه آخر القواعد العلمية الاقتصادية المثبتة تطبيقيا.
العاجز عن أن يبدأ بعمل جديد من دون إعالة تكفل تنقلاته ومصروفه سيبقى عاطلا عن العمل، وغائبا عن أي إنتاج أو أمل بمستقبل؛ أمام نسبة الإعالة الصادمة، ننصدم أكثر أن المسنين 7% منهم فقط لديهم من يعيلهم ويساعدهم لتدبر حياتهم؛ أما الشباب فـ 63% منهم من يحتاج إلى معيل ليستطيع تأمين الحد الأدنى من معيشته وطعامه يوميا؛ فنحن في مرتبة 46 من أصل 180 دولة في العالم مرتبة متقدمة جدا من السكان التي تحتاج لمعيل، وغالبا ما يكون خارجيا، مما يفسر الارتفاع المضطرد من الحوالات الواردة إلى البلاد، والتي يستخدمها السكان لتحقيق توازن بين إنفاقهم على الفواتير وبين رواتب بخسة تقدّم مقابل العمل.
يبدو الآن أن أولى المعضلات الاقتصادية الداخلية التي تحتاج إلى حل سريع، هي إيجاد حل للهاوية بين الإنفاق والدخل للفئات الثلاث المذكورة هنا؛ الفلاحين والعمال والمحتاجين للإعالة سواء كانوا موظفين أو لا. وتندرج ضمن هذه الشريحة فئة الجرحى وذوي الشهداء وموظفي القطاع العام والعاطلين عن العمل كليا؛ فدعم هؤلاء سيؤدي ببساطة لدعم ثلث اقتصاد البلاد برمته بنهضة متسارعة الخطى، ودعم ثلاثة أرباع الشعب السوري، مما سيكون نواة لحل مشكلة جديدة ستعترض الاقتصاد السوري بعد الراحة من الأزمات اليومية المتكررة، ألا وهي فقدان المواد الأساسية الغذائية والتي من المتوقع أن يدق ناقوسها كلما زاد الضغط على فئات الشعب الثلاث هذه، بتجاهل أحقيتها بطلب الدعم المكفول بالدستور السوري. وهذا له من الحساسية الاقتصادية ما يوازي حساسية إنهاء الأزمات الاقتصادية اليومية بالإنتاج ودعمه بدلا من الاستيراد ودعمه
المصدر- الأيام- د. نسرين زريق



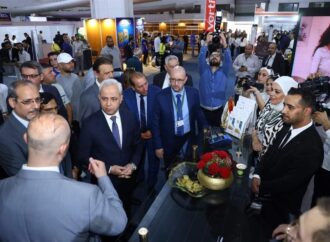
















اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *